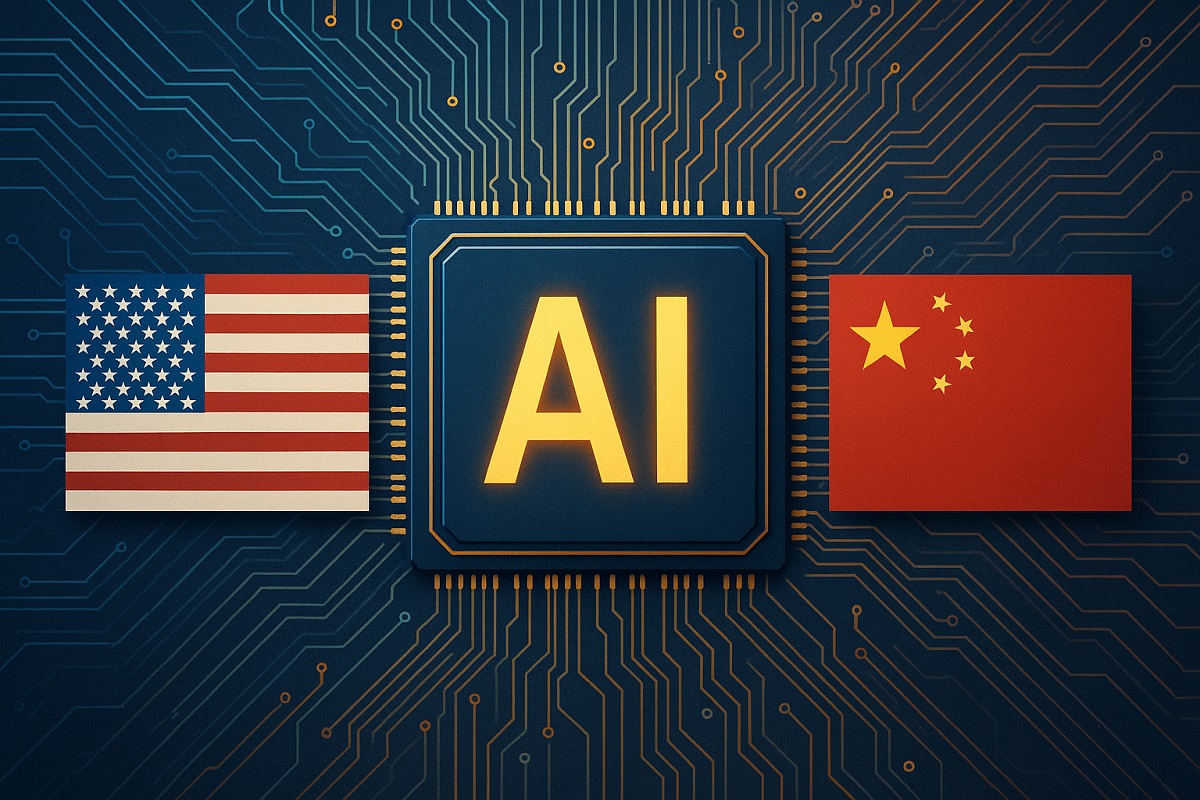بين تصاعد التنافس الأميركي–الصيني وتحوّل الخليج إلى مركزٍ ناشئ للذكاء الاصطناعي، تجدُ واشنطن وبكين نفسيهما في سباقٍ لكسب عقول المنطقة وبياناتها، حيث تُختبر توازنات القوة من خلال التكنولوجيا لا الجغرافيا.
أندرو ليبِر*
تُقدّم دول الخليج العربي مثالًا بارزًا على الانعكاسات السياسية لتصاعُد النفوذ الاقتصادي العالمي للصين، الذي تقوده قدراتها التصنيعية الضخمة وتطوّرها التكنولوجي المُتسارع. فعلى الرُغم من أنَّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ترتبطان منذ عقود بشراكةٍ أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، فإنَّ تزايدَ اعتماد الصين على واردات الطاقة من المنطقة أثار على مدى السنوات الماضية تساؤلاتٍ حول احتمال سعي بكين إلى دورٍ أمني أوسع في الخليج. إلّا أنَّ هذا الاحتمال لم يتحقّق، ومن غير المرجّح أن يتحقق في المدى المنظور. ومع ذلك، فإنَّ التشابك الاقتصادي العميق والمتنامي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي يقلّص من استعداد هذه الدول لاصطفافٍ سياسي كامل إلى جانب واشنطن، باستثناء القضايا الأمنية الأساسية مثل صفقات التسليح.
تُمثّلُ تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثَ محورٍ للتنافس في سياق النفوذ الأميركي–الصيني المُتصاعد داخل منطقة الخليج. وتتركّز النقاشات الحالية على سعي دول الخليج إلى الحصول على الرقائق الدقيقة المتقدّمة التي تُنتِجها شركة “إنفيديا”(NVIDIA) الأميركية، والاستفادة من الخبرة التقنية الأميركية الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد صوّرَ مسؤولون من الجانبين، الأميركي والخليجي، توسيع الوصول إلى هذه الرقائق والخبرات كفرصةٍ لتعزيز التقارب مع واشنطن، بعد سنواتٍ من التمدّد المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وبكين.
غير أنَّ هذا التقارب التكنولوجي، مهما كانت فوائده أو مخاطره، لن يُبدِّلَ بالضرورة النظرةَ الراسخة لدى قادة الخليج، الذين ما زالوا يرون التعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة خيارًا عمليًا في الحاضر، بينما يواصلون الاستثمار في علاقاتٍ اقتصادية أعمق مع الصين في المستقبل المنظور. فالتنامي المستمر للعلاقات الاقتصادية الخليجية–الصينية يعكسُ واقع الحضور الاقتصادي العالمي للصين أكثر مما يعكس نجاح الجهود الأميركية “الانتقائية” الرامية إلى استعادة نفوذها في الخليج. ومن ثم، فإنَّ ما يُعرَفُ اليوم بـ”ديبلوماسية الذكاء الاصطناعي” لا يُعَدُّ حلًا سريعًا يُتيحُ لواشنطن استعادة موقعها بسهولة، ولا وسيلة مضمونة لتغيير موازين الولاء السياسي، خصوصًا في ظلّ تراجع قدرتها على إنتاج ابتكارات تكنولوجية جديدة بالزخم السابق.
نقطة التقاطع
في هذا السياق، تبرز ما يُمكن وصفه بـنقطة التقاطع في التفكير السياسي الأميركي حول دور الصين في الشرق الأوسط. فصنّاع القرار في واشنطن يناقشون منذ سنوات اللحظة التي قد تتحوّل فيها العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الصين والمنطقة، ولا سيما مع دول الخليج، إلى عاملٍ يُثيرُ أو يسمح بصراع أوسع مع المصالح الأميركية. ففي العام 2008، أشار الباحثان الأميركيان جون ألترمان وجون غارفر، في معرض حديثهما عن سُبُلِ تعزيز التعاون الأميركي–الصيني، إلى “احتمال نشوء صراع أكبر” بين القوتين في هذه المنطقة. وقد بدأت ملامح ذلك الاحتمال تتجسّد في السنوات اللاحقة، مع تزايد اعتماد الصين على واردات النفط الخام من الخليج في الوقت الذي تراجعت الإمدادات المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة.
ينطلق الإطار التحليلي السائد في واشنطن من افتراضٍ مفاده أنَّ اعتمادَ الصين المتزايد على واردات النفط من الخليج سيقودها في نهاية المطاف إلى توسيع حضورها الأمني في المنطقة، على نحوٍ يشبه ما قامت به الولايات المتحدة خلال حقبة الحرب الباردة، ولا سيّما منذ حرب الخليج الأولى عام 1990–1991. وقد عبّر عن هذا التصوّر بوضوح قائد القيادة المركزية الأميركية السابق، الجنرال كينيث ماكنزي، في مقابلة أُجرِيت معه في العام 2020، حين وصف العلاقات الاقتصادية الصينية–الخليجية بأنها محاولة لبكين لـ”إنشاء رأس جسر” قد يفتح المجال لاحقًا أمام تعاونٍ عسكري أوسع، سواء من خلال مبيعات أسلحة أو حتى وجود أمني مباشر على غرار الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، أو القواعد الأميركية الدائمة في الكويت وقطر. واستنادًا إلى هذا المنظور، تُثير أيُّ مؤشرات على تعاونٍ عسكري أو تقني بين الصين ودول الخليج اهتمامًا إعلاميًا أميركيًا واسعًا، كما يظهر في التغطية المستمرة لتقارير حول تعاون سعودي–صيني محتمل في مجال تطوير أو شراء الصواريخ الباليستية.
وحتى في الوثائق الرسمية الأميركية التي تُقرّ بضعف اهتمام بكين بالتعامل مع التحديات الأمنية المزمنة في الشرق الأوسط، تُقدَّم السياسة الصينية على أنها جزء من مشروع أوسع لبناء نظام عالمي غير ليبرالي ينافس النظام الذي تقوده الولايات المتحدة. ويرى بعض المعلقين الأميركيين أنَّ أيَّ ضغط سياسي أو ديبلوماسي تمارسه واشنطن على شركائها الخليجيين—خصوصًا في قضايا مثل حقوق الإنسان—قد يدفعهم إلى التقارب أكثر مع الصين. ولعل أبرز مثال على ذلك الدور الصيني المحدود في التوسط بين السعودية وإيران في العام 2023، والذي حظي باهتمامٍ كبير في الأوساط الأميركية بوصفه مؤشرًا إلى تحوّلٍ مُحتَمل في موازين النفوذ الإقليمي. كما تُثار المخاوف من أنَّ استخدام مبيعات الأسلحة الأميركية كأداة ضغط يمكن أن يمنح شركات الصناعات الدفاعية الصينية فرصة لتعويض الفراغ، وهو الطرح الذي تبنّاه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
ورغم هذه التصوّرات الواسعة في الخطاب الأميركي، فإنَّ هناك إجماعًا ضمنيًا بين الخليجيين والصينيين ومعظم المحللين الأميركيين على أنَّ الصين لا تعتزم لعب دور أمني مباشر أو جوهري في الخليج في المستقبل القريب. وقد خلص الباحثان محمد السديري وأندريا غيزيلي في دراسة حديثة إلى أنَّ غالبية الخبراء الصينيين في شؤون السياسة الخارجية تعارضُ أيَّ التزامات عسكرية في الشرق الأوسط، معتبرةً أنَّ تكاليف الانخراط الأمني تفوق مكاسبه بكثير. وفي الخليج، لا يبدو أنَّ أحدًا يتوهّم العكس؛ فالمعلّقون السعوديون، بحسب الدراسة ذاتها، لا يتوقعون أن تتولى الصين دورًا أمنيًا مباشرًا، وإن كانوا يرون في التلويح بالتقارب مع بكين أداة تفاوضية فعّالة يمكن توظيفها للحصول على تنازلات من واشنطن.
أما لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، فقد أشارت في تقريرها لعام 2024 إلى أنَّ الصين، رُغم طموحاتها الاقتصادية الواسعة، لا تبدو راغبة في الحلول محلّ الولايات المتحدة كمزوّد رئيسي للأمن في الشرق الأوسط، ولا في بناء شبكة تحالفات عسكرية تماثل تلك التي أرستها واشنطن على مدى عقود.
يُظهر اعتماد دول الخليج على المظلّة الأمنية الأميركية استمراريةً واضحة في مبيعات الأسلحة الأميركية للمنطقة، رغم الشكاوى المتكررة من بعض قادة الخليج بشأن الضغوط الأميركية المرتبطة بحقوق الإنسان أو القلق من موثوقية الالتزامات الأمنية لواشنطن.
ورغم أنَّ عددًا من دول مجلس التعاون الخليجي –وفي مقدّمتها الإمارات العربية المتحدة وقطر– سعى إلى تنويع مصادر تسليحه بعيدًا من الولايات المتحدة عبر شراء معدات من دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، فإنَّ المؤشرات المتاحة لا تدعم احتمال توجهٍ قريب نحو بكين كمزوّدٍ للأمن أو السلاح.
بل إنَّ مبيعات الصين المحدودة من الأسلحة إلى دول الخليج تتبع نمطًا ثابتًا يتمثّل في صفقات الفُرَص؛ أي الحالات التي تُستبعَد فيها واشنطن وشركاؤها الأمنيون الغربيون صراحةً من البيع. وينطبق هذا على قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، التي لجأت دوريًا إلى شراء صواريخ باليستية بعيدة المدى من الصين منذ ثمانينيات القرن الماضي، في فترات كان التعاون الأميركي فيها مُقَيَّدًا أو خاضعًا لشروط صارمة.
وبالمنطق ذاته، فإنَّ التدريبات العسكرية المشتركة التي تُجريها الصين بين حينٍ وآخر مع بعض دول مجلس التعاون لا تعبّر عن تحوُّلٍ استراتيجي، بل تظلُّ محدودة الطابع والهدف، إذ لم تُنشِئ الصين حتى الآن وجودًا عسكريًا دائمًا في الخليج على الرُغم من التكهّنات المتكررة حول نواياها في هذا الصدد.
ورُغمَ أنَّ الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل يُعَدُّ من أكثر العوامل التي تُربِكُ علاقات واشنطن مع شركائها الخليجيين، فإنَّ ذلك لم يؤدِّ إلى قطع التعاون العسكري بين الطرفين. بل إنَّ بعض التقارير أشارَ إلى أنَّ عددًا من دول الخليج قدّم مساعداتٍ مُحدَّدة لإسرائيل بناءً على طلبٍ أميركي أثناء الهجوم الإيراني في نيسان (أبريل) 2024. وحتى عندما أثارت الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة في أيلول (سبتمبر) 2025 تساؤلات جديدة بشأن موثوقية الولايات المتحدة كضامنٍ للأمن الإقليمي، كانت الاستجابة الأولية من قِبل دول الخليج تعزيز الشراكات الأمنية الإقليمية (كما فعلت السعودية) وطلب المزيد من الضمانات الأمنية الأميركية (كما فعلت قطر)، لا التوجّه نحو الصين أو البحث عن بدائلٍ آسيوية.
السياق الاقتصادي
في المقابل، لا يمكن تجاهل أنَّ الاقتصاد أصبح ساحة التداخل الأبرز بين الخليج والصين. فمنذ العام 2008، تضاعفت واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الصين ثلاث مرات تقريبًا، في حين استقرّت وارداتها من الولايات المتحدة منذ العام 2012. ويعني ذلك أنَّ التحالفات الأمنية الخليجية مع واشنطن ستظل قائمة في المدى المنظور، لكن الاعتبارات الجيوسياسية لقادة الخليج ستتكيّف مع الحقائق الاقتصادية الجديدة لعالمٍ باتت فيه الصين قادرة على توفير طيفٍ واسع من السلع بأسعار تنافسية وجودة مقبولة.
وبذلك، تتشكّل ملامح علاقة مزدوجة الأبعاد: أمنٌ تقليدي مرتبط بالولايات المتحدة، واقتصادٌ متسارع التشابك مع الصين. هذا التوازن البراغماتي –القائم على الانفتاح شرقًا مع الحفاظ على الحماية الغربية– يُجسّد النهج الخليجي في إدارة التحوُّلات الكبرى في النظام الدولي الراهن.
يُمكن النظر إلى قطاعِ السيارات بوصفه مثالًا واضحًا على التحوّلات الاقتصادية الجارية في العلاقة بين الخليج والصين. فلطالما شكّلت السيارات الأميركية جُزءًا مهمًّا من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حتى في ظلِّ هيمنة الشركات اليابانية والأوروبية على الحصص السوقية الأكبر. غير أنَّ هذه الأسواق، بخلاف السوق الأميركية شبه المُغلَقة أمام المنتجات الصينية، أصبحت مُنفَتِحة بشكلٍ متزايد على الصادرات الصينية التي شهدت نموًّا لافتًا في السنوات الأخيرة، مدفوعةً باستثماراتٍ ضخمة وطويلة الأمد في هذا القطاع وبقدرةٍ إنتاجية تفوق كثيرًا حجم الطلب المحلي في الصين.
وخلال الفترة بين العامين 2021 و2024، بلغت حصة السيارات الصينية منخفضة الكلفة –من شركات مثل ” JAC” و”GAC” و”SAIC”- نحو 14 في المئة من واردات السيارات الخليجية من حيث القيمة، بعدما كانت شبه معدومة قبل عقد واحد فقط. لقد أصبح هذا التغيُّر واقعًا ملموسًا لا يمكن تجاهله. فعندما زرتُ مدينة أبها السعودية في أيار (مايو) الماضي، كانت السيارات الصينية منتشرة في معارض التأجير بشكلٍ واسع، في مشهدٍ يعكسُ التحوُّل المتسارع في طبيعة الخيارات الاستهلاكية الخليجية.
ويتكرّرُ النمطُ نفسه في مجال التكنولوجيا المُتقدِّمة، حيثُ لا تقتصر العلاقات بين دول الخليج والصين على الاستيراد، بل تشملُ أيضًا مشاريع تطوير محلية مدعومة بشراكاتٍ عالمية. فقد لعبت شركات التكنولوجيا الصينية دورًا محوريًا في تحديث وتوسيع شبكات الاتصالات وسعات تخزين البيانات في دول مجلس التعاون، وغالبًا ما قدّمت عروضًا بأسعار أقل بكثير من منافساتها الغربية، ما جعلها شريكًا مُغريًا من الناحية الاقتصادية.
تظهر آثارُ هذا الانخراط بوضوح في بيانات التجارة الإجمالية. فعلى سبيل المثال، شكّلت البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس (5G) إحدى أبرز ساحات التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين في الخليج. وبالنظر إلى أحد المكوّنات الرئيسة لهذه البنية –محطات القاعدة الخاصة بأبراج الاتصالات (رمز النظام المنسق 8517.61)– خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، نجد أنَّ المنتجات الصينية مثّلت نحو 80 في المئة من واردات دول الخليج في هذا المجال الحيوي.
وينسحب هذا الاتجاه على سلاسل التوريد الأخرى في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، والتي تشكل بدورها ركيزة أساسية في استراتيجيات التنويع الاقتصادي لكل من السعودية والإمارات. ففي إطار مساعيها لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة، زادت الرياض بشكل ملحوظ من وارداتها من أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بها، واستحوذت الشركات الصينية على حصة معتبرة من هذه السوق، إلى جانب شركاء آسيويين آخرين.
كما استوردت كلٌّ من الإمارات والسعودية نسبة كبيرة من الرقائق الدقيقة المتقدمة من الصين، بينما استمرّت الولايات المتحدة كمصدر رئيسٍ لبقية الواردات في هذا القطاع داخل الخليج. ويُظهر هذا التوزيع المزدوج –بين المورِّدين الأميركيين والصينيين– النهج العملي الذي تتبعه دول الخليج في إدارة انفتاحها الاقتصادي: الإفادة من التكنولوجيا الغربية المتقدمة من جهة، ومن الكفاءة والتكلفة المنخفضة للتكنولوجيا الصينية من جهة أخرى.
وبذلك، لا يُعَدّ تمدُّد الحضور الصيني في الأسواق الخليجية مسألة تجارية فحسب، بل تعبيرًا عن توازن جديد في علاقات الاعتماد المتبادل، حيث تتحوّل الصين تدريجًا من موردٍ بديل إلى شريكٍ اقتصادي رئيس في قطاعاتٍ استراتيجية تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والاتصالات، وصناعة المركبات.
بداية جديدة مع الذكاء الاصطناعي؟
يبدو أنَّ تنامي الأهمية الاقتصادية والسياسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي منح الولايات المتحدة موطئ قدمٍ جديدًا في سباق المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية مع الصين. فمنذ سنوات، تسعى الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى تقييد وصول بكين إلى أشباه الموصلات ورقائق الحوسبة المتقدّمة، باعتبارها بوّابة الحفاظ على التفوُّق التكنولوجي، وبالتالي النفوذ الجيوسياسي الأميركي. وفي المقابل، يدور الجدل داخل واشنطن حول الكيفية المثلى لتحويل هذا التفوُّق إلى أداةِ نفوذٍ فعّالة، من دون أن يُعرَّض أمن البيانات الأميركية أو الأسرار التقنية للخطر عبر التسريبات غير المقصودة.
في هذا السياق، برزت دول الخليج العربي كمحورٍ رئيس في النقاشات الأميركية، خصوصًا بعد أن أبرمت إدارة ترامب اتفاقاتٍ مع السعودية والإمارات سمحت لهما بالوصول إلى رقائق “إنفيديا” (NVIDIA) المتقدّمة. وقد رُوِّج لتلك الاتفاقات بوصفها خطوة لتعزيز الشراكات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والتصدّي في الوقت ذاته لمخاوف واشنطن من احتمال تسرُّب التكنولوجيا إلى الصين عبر قنوات غير مباشرة.
وتُعَدُّ الإمارات النموذج الأبرز لاختبار مدى فعالية ما يمكن تسميته بـ”ديبلوماسية الذكاء الاصطناعي” الأميركية. فبخلاف غيرها، تُظهر الإمارات قدرة واضحة على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. إذ تمتلك الدولة منظومةً مؤسّساتية متكاملة يقودها كيانٌ مدعوم من الحكومة هو “مجموعة 42” (G42)، التي تأسّست عام 2018 برئاسة أحد أفراد العائلة الحاكمة، وتستند إلى قاعدة بحثية وتعليمية متينة تشمل جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، لا تزال التجربة السعودية في هذا المجال تتخذ شكل المبادرات الناشئة، مثل مشروع “هيومَاين” (HUMAIN) الذي يسعى إلى تجاوز أداء “الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي” السابقة. أما الإمارات، فقد نجحت في ترسيخ صورتها كشريكٍ مفضَّل للولايات المتحدة في تطوير هذه التكنولوجيا. فقد أعلنت “مجموعة 42” عن فكِّ ارتباطها بشركة هواوي الصينية، وسحب جميع أجهزتها من منشآتها وبيع استثماراتها في الشركات الصينية، في خطوةٍ تهدف إلى طمأنة واشنطن وضمان موافقة إدارة جو بايدن على صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة “مايكروسوفت”.
أبدى المسؤولون الإماراتيون استعدادًا واضحًا لدفع ثمنٍ مرتفع لقاء الحصول على أحدث التقنيات الأميركية. فقد تعهّدوا، وفق تقارير عدة، باستثمار مليار دولار إضافي في الولايات المتحدة مقابل كل مليار دولار يُسمح لهم بإنفاقه على شراء رقائق “إنفيديا” (NVIDIA) المتقدّمة — في صفقةٍ تعكس مدى إدراكهم لأهمية بناء الثقة مع واشنطن. وفي إشارةٍ لافتة إلى تشابك المصالح السياسية والاقتصادية في العلاقات الحالية، جاءت هذه الصفقة متزامنةً مع استثمارٍ إماراتي كبير في عملةٍ رقمية مملوكة جُزئيًا لعائلة ترامب، ما أضفى على المشهد بُعدًا سياسيًا غير مُعلَن لكنه واضح الملامح.
معضلة التوافق في الذكاء الاصطناعي
رُغمَ هذا الانفتاح، يُستبعَد أن تنحازَ الإمارات كليًّا إلى أيٍّ من المعسكرين الأميركي أو الصيني، على نحو ما ألمحت إليه رسالةٌ حديثة من الكونغرس الأميركي. فالسياسة الخارجية الإماراتية أثبتت مرارًا قدرتها على الحفاظ على توازُنٍ دقيق بين القوى الكبرى، حتى في مواجهة الضغوط الأميركية المباشرة. ففي ذروة جائحة “كوفيد-19” مثلًا، كانت الإمارات أول من قبل بتوزيع لقاح “سينوفارم” الصيني على نطاق واسع، بينما ترددت السعودية لأشهر في اعتماد لقاحَي “موديرنا” و”أسترازينيكا” الغربيين. كما لم تتردّد أبوظبي في الانضمام إلى مجموعة “بريكس” إلى جانب الصين وروسيا، وشاركت بفعالية في قمة قازان الروسية في العام 2024، في حين أبقت الرياض موقفها “قيد الدراسة” من دون التزامٍ رسمي.
تراكمت فوق ذلك الشكوكُ الأميركية بشأن نشاطٍ عسكري صيني مُحتمل في ميناء خليفة بأبوظبي، وهو ما أدّى إلى تعطيل بعض صفقات السلاح الأميركية الحساسة مع الإمارات. ومع ذلك، لم تُبدِ أبوظبي تراجعًا كبيرًا عن استراتيجيتها المتوازنة؛ فبعد زيارة الرئيس ترامب لها في أيار (مايو)، قاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى إلى الصين لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، في مشهدٍ يعكس استمرار النهج البراغماتي الإماراتي.
ويمتدُّ هذا التوازن أيضًا إلى مجال الذكاء الاصطناعي نفسه، حيث تحافظ الإمارات على خيوطِ تواصُلٍ متينة مع بكين. فقد أشار تقريرٌ لمجلة “وايرد” (Wired) حول الشيخ طحنون بن زايد إلى أنَّ الصين لم تُبدِ أيَّ اعتراضٍ علني على انتقال الإمارات لتوثيق التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال، وهو ما يُرجَّح أنه نتاجُ تفاهُمٍ غير مباشر بين الجانبين. وحتى حينما باعت “مجموعة 42” أصولها المرتبطة بالصين، انتقلت هذه الأصول إلى شركة إماراتية أخرى هي “لونيت” (Lunate)، التي تخضع أيضًا لإشراف الشيخ طحنون.
في المقابل، استمرَّ التنسيق الديبلوماسي والعلمي بين بكين وأبوظبي بوتيرةٍ نشطة. فقد التقى وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني ين هيجون مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء خلال مؤتمر الصين العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، كما عقد السفير الصيني لدى الإمارات تشانغ يي مينغ اجتماعات لاحقة مع العلماء في دبي لبحث “سُبُل التعاون العملي” في هذا المجال.
وهكذا، يبدو أنَّ توصيفَ الولايات المتحدة كـ”شريك مفضّل” للإمارات في الذكاء الاصطناعي قد يكون، في جوهره، أقرب إلى التفاهم التكتيكي منه إلى التحالف الاستراتيجي العميق. فبينما تسعى واشنطن إلى تثبيت نفوذها التكنولوجي عبر الخليج، تمضي أبوظبي في اتباع سياسة توازنٍ مرنة تضمن لها البقاء لاعبًا محوريًا في كلا المعسكرين، لا تابعًا لأيٍّ منهما.
سيكون صانعو السياسات في واشنطن محظوظين إن تمكّن نفوذهم من بلوغ الحد الأدنى: حماية التكنولوجيا المتقدمة من أعين المراقبة الصينية، فضلًا عن تحقيق أيّ إعادة هيكلة حقيقية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. فحتى اليوم، تخلّت الإمارات عن مسعاها لشراء مقاتلات “أف-35” المتطوّرة بدلًا من معالجة الهواجس الأميركية المتعلّقة بعمق علاقاتها الاستراتيجية مع الصين، كما لم يتمكن القادة الإماراتيون بعد من إقناع وزير التجارة هوارد لوتنيك بالسماح بتدفق الرقائق الدقيقة مباشرةً إلى “مجموعة 42” من دون المرور عبر الشركات الأميركية المتمركزة في الإمارات.
ورُغم أنَّ التنافس مع الصين في الخليج يُقدَّم كمبرّرٍ رئيس لصفقات التكنولوجيا الأخيرة، فإنَّ هذا المنطق يبدو محدود الأثر. فكما أشار ديفيد ساكس، القيصر الأميركي للذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة في البيت الأبيض، فإنَّ زيادة التعاون بين دول الخليج ووادي السيليكون لن تُقصي الصين من الشرق الأوسط، بل ستضيف طبقة جديدة من التشابك الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى. وإلى جانب ذلك، فإنَّ السياسات الأميركية الداخلية المتشددة —سواء في ما يتعلق بالهجرة أو بالقيود المفروضة على الجامعات— من المرجح أن تدفع بالابتكار التكنولوجي إلى خارج الولايات المتحدة، لتتراجع بالتالي قدرتها على تقديم ما هو أكثر من صفقات الأسلحة لحلفائها الخليجيين.
الخلاصة
من الواضح أنَّ الروابط الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الصين ودول الخليج ستواصل تغذية سرديات “التنافس الأميركي–الصيني” في المنطقة خلال السنوات المقبلة. غير أنَّ هذه السرديات تميل إلى المبالغة في تقدير نوايا الصين الأمنية أو رغبتها في التورّط العميق في منظومة أمن الخليج، كما تُبالغ في تصويرها كبديل استراتيجي كامل للولايات المتحدة. وفي المقابل، تُقلّل الرواية الأميركية من شأن الترابط الاقتصادي البنيوي بين الصين والخليج، والذي يتجاوز تجارة الطاقة ليشمل التعاون في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، والتنويع الاقتصادي الذي يُشكّل جوهر رؤى التنمية الخليجية.
وعليه، ينبغي تقييم صفقات التكنولوجيا الأميركية في المنطقة بميزانٍ أكثر واقعية:
- هل يمكن ضمان حماية البيانات من الاختراق أو إساءة الاستخدام؟
- هل تُعرّض مراكز البيانات الأميركية في الخليج واشنطن لمخاطر جيوسياسية إضافية؟
- وهل تضمن هذه الصفقات ألّا تُستغل التقنيات الناتجة عنها في تأجيج النزاعات الإقليمية أو في تعزيز أدوات القمع الداخلي؟
إنّ الفوائد الاقتصادية المباشرة لهذه الصفقات —من تدفق رؤوس الأموال، وتوفير الطاقة لمراكز البيانات، وتحرر بعض شركات التكنولوجيا من قيود الرقابة السياسية في الداخل الأميركي— واضحة ومُغرية. غير أنَّ تلك المكاسب لن تؤدّي إلى إعادة تموضع اقتصادي شامل في المنطقة لصالح الولايات المتحدة، ولا إلى تراجعٍ جوهري في النفوذ الصيني. فبدون إصلاحاتٍ أوسع داخل الاقتصاد الأميركي تُعيد له القدرة على تقديم بدائل صناعية واستهلاكية منافسة، فإنَّ شراكات التكنولوجيا الحالية قد تفتح الباب أمام اختراقٍ رقمي محتمل للبنية التحتية الأميركية، مع عائد استراتيجي محدود يختزل العلاقة في تبادل رأس المال مقابل التكنولوجيا، لا أكثر.
- أندرو ليبر هو باحث غير مقيم في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط. وهو أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية وبرنامج دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة تولين.
- كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.