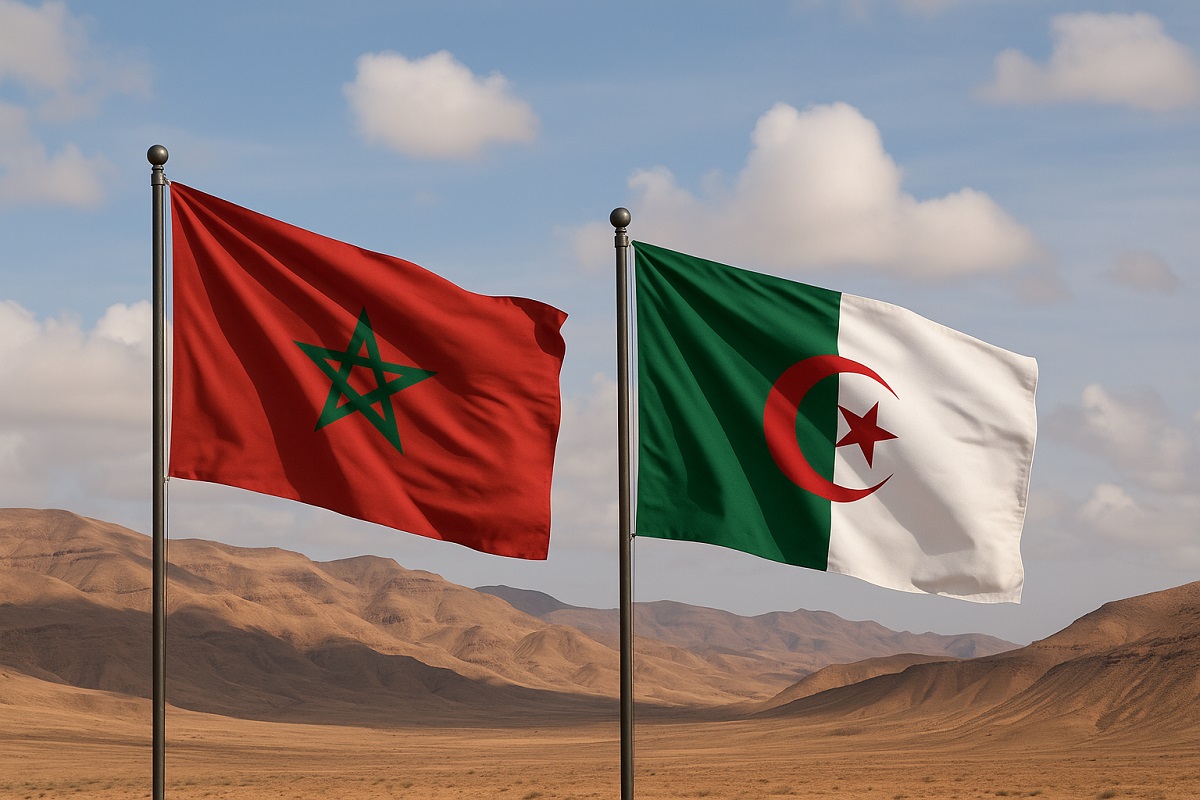كابي طبراني*
منذ استقلالهما، لم يعرف المغرب والجزائر سلامًا باردًا ولا حربًا ساخنة، بل عاشا على إيقاعِ خصومةٍ تُجَدَّدُ وتتجدّدُ مع كلِّ جيل. صراعٌ تتبدّل عناوينه بين الحدود والسيادة والقيادة الإقليمية، لكنه يظلُّ في جوهره معركةً على الذاكرة والمستقبل معًا. واليوم، بينما تُعيدُ التحوُّلاتُ الجيوسياسية رَسمَ خرائط النفوذ في شمالِ أفريقيا، يطفو سؤالٌ قديم بثوبٍ جديد: هل يستطيع البلدان كَسرَ الحلقة المُغلَقة التي كبّلت المغرب العربي لعقود؟
الرهاناتُ كبيرة. فإقليمٌ يضمّ نحو مئة مليون نسمة يعيش في حالةِ شلل: حدوده مُغلَقة، تجارته مُكبَّلة، ومشروعاتُ تكامله الاقتصادي مؤجّلة إلى أجلٍ غير مسمّى، فيما تُراقبُ القوى الكبرى ممرّاته الطاقوية ومسارات الهجرة منه وشراكات أمنه. وربما يكون المسعى الأميركي الأخير للتوسّط بين الرباط والجزائر أقلّ عن “صنع السلام” وأكثر عن إعادةِ تموضُعٍ في لعبة النفوذ الدولي، غير أنّه —إن أُحسِنَ استثماره— قد يفتحُ البابَ أمامَ بدايةِ مسارٍ من التهدئة المُنتَظَرة في المغرب الكبير.
لم تنشأ الخصومة بين البلدين من الإيديولوجيا بقدرِ ما وُلِدَت من الجغرافيا. فبعد استقلال الجزائر في العام 1962، فجّرَ الخلافُ على ترسيم الحدود حربَ الرمال في العام 1963، التي كانت قصيرة لكنها رَسَّخَت الانقسام. ومنذُ ذلك الحين، تحوّل نزاع الصحراء الغربية إلى ذريعةٍ وصراعٍ في آن واحد — العنوان الأبرز لمُنافسةٍ أعمق على الزعامة الإقليمية. فالنظام الملكي في المغرب بنى جُزءًا كبيرًا من شرعيته على مفهوم “الوحدة الترابية”، بينما رَسّخَ النظامُ العسكري في الجزائر صورته كحارسٍ لمبادئ الثورة وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.
تَصَلّبت هَوِيَّتان مُتناقضتان مع مرور الزمن. انفتح المغرب على الغرب، وحَرّرَ اقتصاده، وطرح نفسه جسرًا بين أفريقيا وأوروبا. أما الجزائر فتمسّكت بسيادة الدولة وبالاقتصاد المُوَجَّه، وبحذرٍ شديد مما تعتبره توسُّعًا مغربيًا وتوظيفًا غربيًا لخصومها. ومع تباعُدِ النماذج، تباعدت الطموحات أيضًا — فالمغرب يستثمرُ في البنى التحتية والممرّات الطاقوية عبر القارة، والجزائر تستثمرُ في السلاح والطاقة التقليدية.
كانت النتيجة جمودًا مُزمِنًا. ففي العام 2021 قطعت الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب بعد تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل واعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لتبلغ الخصومة مستوى غير مسبوق. ومنذ ذلك الحين، حلَّت المناوشات الحدودية، وحروب المعلومات، والرموز المستفزّة محلّ الديبلوماسية. لا أحدَ يُريدُ حربًا، لكن كليهما يتسلّح كما لو أنها آتية لا محالة.
وفي زمن الإعلام الرقمي، انتقلَ الصراعُ من الصحف إلى الفضاء الإلكتروني. فالإعلام الرسمي في البلدين، مدعومًا بجيوشٍ إلكترونية ومؤثّرين مُمَوَّلين، يخوضُ حربًا مفتوحة من التحريض والمعلومات المُضَلِّلة. الخوارزميات تكافئ الغضب، والوسوم القومية تشتعلُ أسبوعيًا، والإهاناتُ تعبرُ الحدودَ أسرع من الديبلوماسيين. هذه الحربُ الإعلامية تُحوِّلُ سوءَ الفهم إلى سياسة، وتجعلُ كلَّ إشاعةٍ عن تحرّكٍ عسكري “دليلًا على عدوان”، وكلَّ خطابٍ رسمي “تهديدًا مُبطّنًا”. ومع غيابِ قنواتِ اتصالٍ مباشرة، يصبح خطر سوء التقدير قائمًا في كلِّ لحظة.
يرى بعض المحلّلين أنَّ الحلَّ الأوّل يجب أن يكونَ “وقف إطلاق نار في الكلام لا في السلاح”. أي وقف الحملات الإعلامية المُتبادَلة، وفتح خطّ اتصالٍ مباشر ومتعدّد المستويات يربط وزارتَي الخارجية والدفاع ورأسَي الحكومتين. “تحدّث قبل أن تُغرِّد”، كما يقولُ المثلُ الجديد في زمن الأزمات.
وسط هذا المناخ المشحون، جاءت مبادرة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي أعلن أنَّ فريقه يسعى إلى التوصّل إلى “اتفاق سلام” بين المغرب والجزائر خلال ستين يومًا. لكن عن أيِّ سلامٍ يتحدث؟ فالبلدان ليسا في حالة حربٍ فعلية، بل في صراعٍ دائم من دون معركة. صحيحٌ أنَّ ملفَّ الصحراء الغربية هو جوهرُ الخلاف، لكنه ليس كلّه. حتى تسوية أممية تقوم على “الحكم الذاتي” تحت السيادة المغربية لن تُنهي التنافس البُنيوي بين الطرفَين. غير أنّ واشنطن ترى فرصةً لربط الحلّ السياسي بمشروعٍ أوسع للتكامل الاقتصادي والأمني في المغرب العربي تحت مظلة غربية.
هذا النهجُ براغماتي أكثر منه مثالي، فالاتفاقُ المُحتَمَلُ يخدمُ أهدافًا متعدّدة: تقاسُم الأعباء مع أوروبا، كبح النفوذين الروسي والصيني، وتأمين خطوط الطاقة إلى البحر المتوسط. أما بالنسبة إلى المغرب والجزائر، فقد يشكّلُ فرصةً نادرة لإعادة صياغة التنافس في شكلِ تعاوُنٍ مُنظّم، يمنح كليهما “سرديّة انتصار” مختلفة: المغرب يُرسّخُ مكاسبه الترابية، والجزائر تحصد مكاسب اقتصادية ودورًا سياسيًا في أمن الساحل الأفريقي.
ورُغمَ كلِّ التوتّر، ما زالت القيادة في كلا البلدين حذرة. فالإِحجامُ عن الحرب ليس دليلَ حكمةٍ بقدر ما هو خوف من المجهول. الجزائر تملك جيشًا ضخمًا يتفوّق عددًا وعتادًا، لكن المغرب يمتلك تفوّقًا نوعيًا في التسليح والتكنولوجيا بفضل شراكاته مع الولايات المتحدة وإسرائيل. حربٌ كهذه ستكون كارثية على الاقتصادَين، وقد تطيح بالشرعية السياسية للنظامَين معًا. لذلك، يُفضّلُ الطرفان حتى الآن إدارة الأزمة بدل تفجيرها. فالمغرب يسعى إلى تثبيت سيطرته على الصحراء الغربية عبر التنمية والديبلوماسية، والجزائر تحاول استعادة صورتها كقوة طاقةٍ موثوقة بعد سنواتٍ من الاضطراب. لكن هذه “الهدنة الباردة” تبدو هشّة. إذ تُغذّي وسائل التواصل الوطنية النزعة القومية، وتؤجّج الانقسامات الداخلية، فيما يزدادُ الضغطُ من القواعد العسكرية والسياسية لرَفعِ سقفِ المواجهة. ومع تململ جبهة البوليساريو واستعدادها المتزايد للتصعيد، بات خطر حادثٍ عابرٍ يتحوّل إلى أزمةٍ كبرى أكثر واقعية من أيِّ وقتٍ مضى.
إنَّ استمرارَ الحرب الباردة المغاربية ليس بسبب غياب الحلول، بل غياب الشجاعة. فكلا النظامَين رهينة روايته الوطنية؛ أيُّ تنازلٍ علني قد يُفَسَّرُ كضعفٍ داخلي. تجاوُزُ هذه العقدة يتطلّبُ قيادةً تملكُ الجرأة لتُقَدِّم التسوية بوصفها انتصارًا للسيادة، وديبلوماسية تفضّل التدرّج الهادئ على الاستعراض. الخطواتُ الأولى واضحة: فتحُ قنواتِ الحوار، وَضعُ ميثاقٍ إعلامي يضبطُ الخطابَ المُتبادَل، وإطلاقُ مبادراتٍ مشتركة للطاقة والهجرة تحت رعايةٍ دولية. بإمكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدة، لكنَّ القرارَ الحقيقي بيد الرباط والجزائر وحدهما.
لقد أصبحَ المغرب العربي أكبر من أن يُختَزَلَ في نزاعٍ حدودي عمره نصف قرن. هو إقليمٌ غنيٌّ بالموارد والفُرَص، وموقعه الاستراتيجي يجعله ضروريًّا لأمن أوروبا وأفريقيا معًا. والمطلوب اليوم ليس الحبّ والعشق بين الجارَين، بل التعايُش. فالمُصالحة لا تعني التنازُل، بل تعني الوعي بأنَّ العداوة لم تَعُد ترفًا سياسيًا. ما تحتاجه المنطقة ليس قمة جديدة ولا شعارًا وحدويًا آخر، بل خطة شجاعة لوقف الانحدار قبل فوات الأوان.
- كابي طبراني هو ناشر ورئيس تحرير مجلة وموقع “أسواق العرب” الصادرَين من لندن. ألّف خمسة كتب بالعربية والإنكليزية من بينها “شتاء الغضب في الخليج” (1991)، “الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: من وعد بلفور إلى إعلان بوش” (2008)؛ “كيف تُخطّط إيران لمواجهة أميركا والهَيمَنة على الشرق الأوسط” (2008)؛ و”معاقل الجهاد الجديدة: لماذا فشل الغرب في احتواء الأصولية الإسلامية”، (2011). يُمكن متابعته عبر موقعه الإلكتروني: gabarielgtabarani.com أو عبر منصة “إكس” على: @GabyTabarani