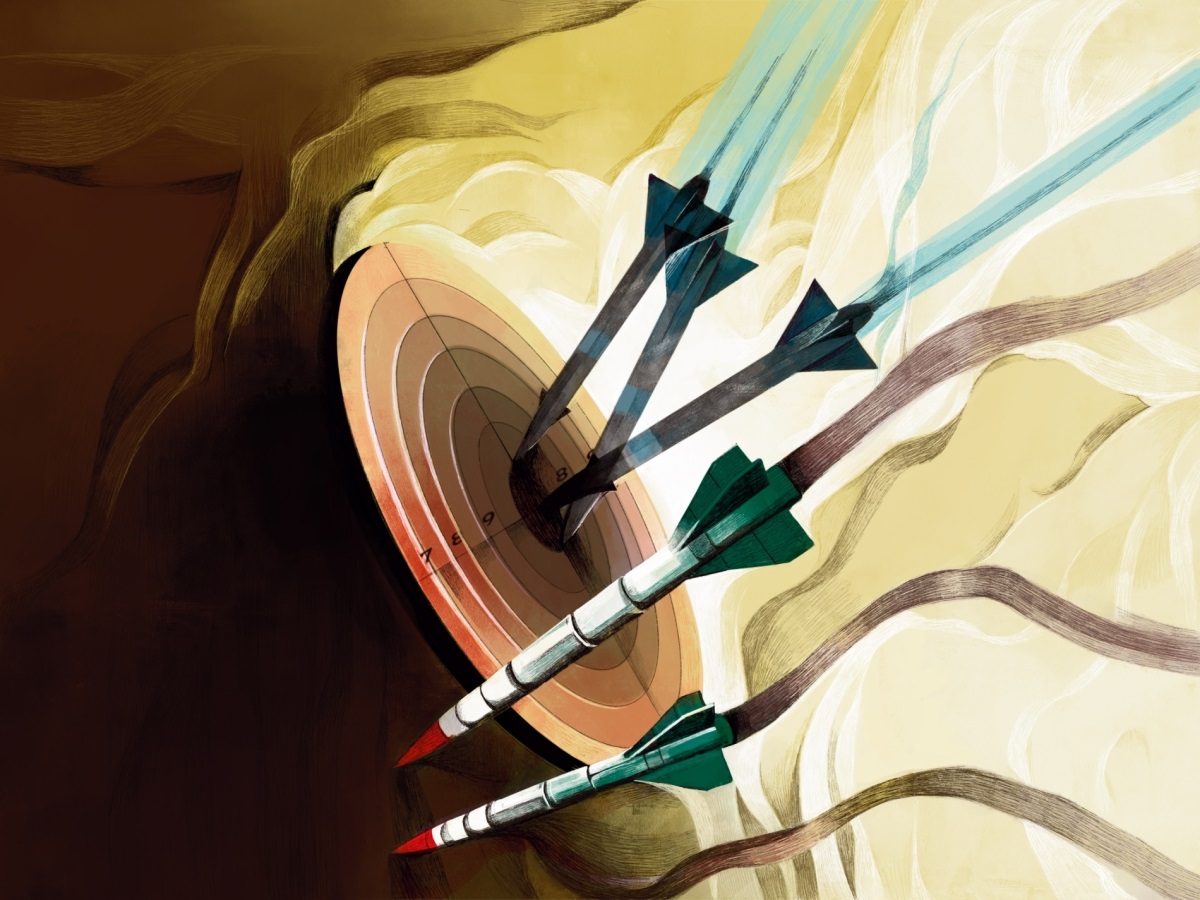الدكتور داوود البلوشي*
في عالمٍ باتَت الدول فيه تبحثُ عن أعدائها كما يبحثُ التاجرُ عن الأسواق، لم تَعُد الحروبُ استثناءً طارئًا، بل ضرورةٌ استراتيجية دائمة منذ نهاية الحرب الباردة. لم تعد واشنطن تطمحُ إلى “سلامٍ عالمي”، بل إلى “عدوٍّ دائم” يُبرّرُ يقظةَ المجمع الصناعي العسكري، ويحافظ على هندسة الهيمنة العالمية.
إيران… من الحليف إلى الشيطان
كانت إيران أيام الشاه محمد رضا بهلوي أس الحربة الأميركية جنوب الاتحاد السوفياتي. كانت طهران قاعدة متقدمة للنفوذ الأميركي، ومفاعل نطنز ليس اكتشافًا ثوريًا لجمهورية الإمام روح الله الخميني الإسلامية بل استمرارٌ لما بدأه الشاه بموافقة الغرب. لكن الثورة الإسلامية أخرجت إيران من الحضن الأميركي إلى موقع “الخصم العقائدي”، فوجدت فيها واشنطن العدو المطلوب بعد أفول الشيوعية.
غير أن هذا العدو ليس موحدًا. فواشنطن نفسها تعاملت مع الشيعة ضد السنّة، ثم مع السنّة ضد الشيعة، بحسب مقتضيات اللعبة. فصدام حسين كان حليفًا ثم صار عدوًا، ثم أصبحت إيران “الشيعية” العدو الأوحد، ثم باتت تفاوضها سرًا وتُهاجمها علنًا عبر إسرائيل.
إسرائيل… الوكيل المتقدم للحرب بالنيابة
إسرائيل ليست فقط “الطفل المُدلَّل” للغرب، بل قاعدة متقدّمة في قلب ثلاث قارات آسيا، إفريقيا، وأوروبا وجودها يبرر التمويل والدعم الغربيين باسم الأمن، ويمنح واشنطن أداة تنفيذ بعيدة من المساءلة المباشرة. فالهجومُ على إيران، والتجسّس على منشآتها، ودعم بعض الجماعات المسلحة، كل ذلك يتم عبر الوكيل الإسرائيلي. وكذلك الحال في غزة، فكلما اقترب الحديث عن “حلِّ الدولتين”، تُفجّرُ إسرائيل حربًا تؤجّلُ الحلَّ وتُعيدُ تعريف الصراع.
الدول العربية: أدوار متفاوتة في مسرح معقّد
السعودية: تمثل القيادة الرمزية للسُنّة، وتحظى باهتمامٍ أميركي خاص، خصوصًا في ظل التحوُّل الأميركي نحو حلف “سنّي” ضد إيران.
قطر: تلعبُ دورَ الوسيط الفاعل والمُموِّل والموازن، بحضورٍ إعلامي فاعل وسياسة براغماتية مع كلِّ الأطراف.
الإمارات: تتقاطع في بعض ملفاتها وتواكب الدور الإسرائيلي في بعض الملفات، وتدعم رؤى تطبيعية وتكنولوجية استراتيجية.
الكويت وعُمان: تتبنيان سياسة الحياد، مع دورٍ محوري لعُمان في الوساطات كما في المفاوضات النووية.
العراق: ممزَّقٌ بين النفوذَين الإيراني والغربي، ويشكّل خاصرة رخوة لإيران من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
تركيا: لاعبٌ حيوي في كل الاتجاهات، بين الإسلام السياسي والبراغماتية الاقتصادية.
باكستان: قوة نووية مجاورة لإيران، لكنها تتجنّب الاشتباك المباشر حفاظًا على توازنها الجيوسياسي المعقد.
الجوار الإسرائيلي وجود لا نفوذ
مصر والأردن: رُغمَ اتفاقات السلام، إلّا أنَّ إسرائيل لا ترى فيهما سوى أدوات عبور أو عزل.
سوريا ولبنان: ساحة اختبار للنفوذ الإيراني، “حزب الله” والردع الإسرائيلي.
فلسطين: حل الدولتين… أم وهم الدولة؟
منذ مؤتمر مدريد (1991) إلى إتفاقيات أوسلو (1993 و1995)، كان حلَّ الدولتين مجرّد غطاءٍ لتفتيت الكيان الفلسطيني. كلما اقترب العالم من إعلان “فلسطين”، أعادت إسرائيل توزيع الخريطة بالحرب او بالاستيطان، أو بالتقسيم السياسي بين غزة والضفة.
حتى الحديث عن دولة واحدة يُخيف إسرائيل ديموغرافيًا، فالفلسطينيون سيتفوقون عددًا، رُغمَ التهويد المستمر.
من الثورة الصناعية إلى الثورة الرقمية
تعيش الرأسمالية الغربية مرحلة ما بعد الذروة. الدَينُ العام الأميركي يتضخّم، الدولار يفقد بريقه، والرقمنة تتجاوز الصناعة، بينما تتقدم أقطاب مثل الصين والهند وروسيا. وهنا تصبح الحروب وسيلة لتأجيل الانهيار أو لإعادة رسم الخرائط والنفوذ.
هل الحرب انتهت… أم بدأت؟
ليس سؤال غزة وحده، بل سؤال الشرق الأوسط كله، هل ما نراه اليوم هو نهاية مرحلة أم مقدمة لخرائط جديدة؟ هل سنشهد تفككًا جديدًا كما حصل في القرن العشرين؟ هل إسرائيل التي نعرفها اليوم ستبقى على حالها، أم أنها مجرد نموذج انتقالي؟
سلام الردع… أم سلام الوهم؟
ما يُسمّى بالردع النووي هو سلام زائف، يؤسّس لاستقرار قائم على شفا الهاوية، لا يمكن للعالم أن يُبنى على توازن الرعب، بل على توازن المصالح والكرامة.
الحرب… أداة إعادة التوازن لا الدفاع
ما يجب التساؤل عنه ليس فقط متى تنتهي الحرب؟ بل لماذا تُشعَلُ أصلًا؟ وهل يمكن أن تتوقّفَ أصلًا؟
في عالم ما بعد الحرب الباردة، لم تَعُد الحروب وسيلةً للدفاع، بل أداةٌ لإعادة التوازن السياسي والاقتصادي العالمي. حين انهار الاتحاد السوفياتي، لم تسعَ الولايات المتحدة إلى شراكة كونية، بل إلى هيمنةٍ مطلقة، تحكّمت بواسطتها في القرار الدولي، والنظام المالي، والعقوبات، وحتى شرعية الحروب. وهكذا بدأت حقبة القطب الواحد، حيث لا ضرورة لتوازنٍ يكبح الغطرسة. مع غياب خصم حقيقي، بدأت أميركا تختلق أعداءها: من الإسلام المُتَشدِّد إلى إيران والإرهاب والصين، إلى روسيا مجددًا. كلُّ عدوٍّ يُستخدَمُ حسب الحاجة، ويُعاد تعريفه حسب اللحظة.
من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعباد
الحرب لم تَعُد استعمارًا بالجيوش، بل استعبادًا بالاقتصاد، بالديون، بالسلاح، وبالتحكم في القرار. وما يفعلهالرئيس دونالد ترامب -بوضوحٍ فجّ– هو النموذج الفاضح لهذا التوجُّه. رئيسٌ لا يقبل معارضة، لا من خصومه ولا حتى من شعبه يُسخّرُ الدولة لصالح نخبة ضيقة، ويستعمل إسرائيل كسلاح سياسي وإعلامي واقتصادي. أميركا اليوم تشبه ما كانت عليه الإمبراطوريات الغابرة في لحظات الانحدار، استبدادٌ داخلي، عدوانٌ خارجي، اقتصادٌ هشّ، ونزعةٌ نحو خلق أعداء بدلًا من بناء الشراكات.
ضرب إيران… وكشف الهشاشة
الهجومُ الإسرائيلي على إيران لم يكن فقط لإضعاف قدراتها، بل لقياس مدى قدرة أميركا وحلفائها على خوضِ حربٍ جديدة في ظلِّ أزماتٍ اقتصادية داخلية. لكن الردَّ الإيراني، الذي جعل معظم القواعد الأميركية في مرمى الصواريخ، كشف هشاشة الحسابات الغربية.
لقد أصبح من الواضح أنَّ الحربَ ليست قرارًا مجانيًا، فهي تؤثرفي الدين العام، في الأسواق، وفي ثقة الشعوب. فكما إنَّ إسرائيل اليوم تخشى من حرب طويلة مع غزة أو “حزب الله” لأنها ستُنهكها اقتصاديًا، كذلك أميركا لا تحتمل حربًا ممتدة تُهدد الدولار، أو تزيد من تفكك الداخل الأميركي.
الحرب على الصين… في عباءة إيران
الحرب الحالية، من غزة إلى إيران، قد تكون واجهة لحرب أعمق ضد الصين. فأميركا تدرك أن تحكّمها في الطاقة والبحار والممرات يُربك الصعود الصيني في الاقتصاد والتكنولوجيا، خصوصًا الذكاء الصناعي. ومن هنا نفهم الحشود في اليابان وتايوان والفلبين وكوريا: احتواء الصين عبر الأطواق العسكرية. لكنّ الفرق جوهري أنَّ أميركا تفكر على المدى القصير… والصين تخطط لمئة عام.
إسرائيل… إلى متى؟
مع التقارب الإيراني-الخليجي، وتنامي النفوذ التركي والروسي، قد تُصبح إسرائيل عبئًا لا أداة. فالتحالفات تتبدّل، والمصالح تتغير، وواشنطن قد لا تحتاج إلى تل أبيب إذا وجدت في أنقرة أو طهران أو الرياض شركاء أكثر براغماتية.
من صراع الدويلات إلى تصادم الإمبراطوريات
الحرب لم تَعُد بين كياناتٍ صغيرة، بل بين كتلٍ كبرى، أي بين الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والاتحاد الأوروبي (ولو ضعيفًا). لكن أدوات الحرب لم تعد الجيوش وحدها، بل الحلفاء بالوكالة، الإعلام، الذكاء الاصطناعي، والسيطرة على الموارد.
الواقع إنَّ ما يجري في غزة ليس مجرّد مشهدٍ دموي، بل عنوانٌ لمرحلةٍ انتقالية كبرى. كل دولة تُستخدَمُ حسب موقعها في الخريطة، وكل تحالف يُبنى على رمال متحركة لا يدوم.
السؤال الحقيقي ليس، متى تنتهي الحرب؟ بل من يُشعلها؟ ولماذا؟ ولصالح مَن تُدار؟
- الدكتور داوود البلوشي هو محام ومستشار قانوني عُماني. حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعةالسوربون في باريس. وهو أستاذ محاضر في جامعة السلطان قابوس في مسقط.